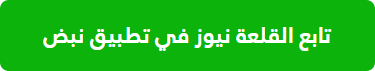القلعة نيوز : يهدف الضمان الاجتماعي(التأمينات الاجتماعية) كنظام تأميني تكافلي عام إلى حماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويلها، وتقوم الحكومات عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام بأداء المزايا والمنافع في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص، مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل وبدلات الأمومة. وتُمَوَّل المزايا من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمّن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وتدخل نُظُم الضمان والتأمينات الاجتماعي في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم اليوم في إطار العمل على تعزيز الأمان الاجتماعي والحماية للأفراد، وارتبطت بفكرة الخطر الاجتماعي الذي يُعرّف بأنه: (كل خطر يؤثّر في المركز الاقتصادي للفرد من خلال إنقاص دخله أو وقفه لتوافر أسباب فسيولوجية كالوفاة والمرض والعجز والشيخوخة، أو لأسباب ذات صلة بالواقع الاقتصادي كالبطالة والفقر وغلاء المعيشة...)
وتأتي أهمية تكييف النظم التأمينية التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط لمواجهة تحديات ضمان الديمومة وضبط النفقات، وإنما أيضاً لتوفير مزيد من الحماية للإنسان، وقد سبقت إليه الكثير من الدول، فقد شهد المؤتمر الثامن للدول الأمريكية الأعضاء في منظمة العمل الدولية المنعقد في أوتاوا (سبتمبر 1966) بحثاً لقضية ملاءمة الرواتب التقاعدية مع التغيرات الاقتصادية في ظل انخفاض القوة الشرائية للنقود، وخرج المؤتمرون بنتيجة حول ضرورة مواءمة المعاشات التقاعدية مع التغيرات الحاصلة في الأوضاع الاقتصادية، لكي تظل المعاشات تكون قادرة على تحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع..
ونفس القضية كانت مثار نقاش مستفيض على مائدة المؤتمر العالمي الرابع عشر للضمان الاجتماعي، والتي أكّد فيها خبراء في نظم التأمينات على أن قضية ملاءمة المعاشات مع التغيرات الاقتصادية في المجتمع لا ترتبط فقط في المدى الطويل بالتضخم، وإنما ترتبط أيضاً بالارتفاع في مستويات المعيشة نتيجة لارتفاع مستوى الأجور، وبالتالي تصبح قضية الملاءمة ضرورية للحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات، وهذه الملاءمة تتخذ جانبين رئيسين هما جانب الاشتراكات التي تدفع لصندوق الضمان، وجانب المزايا والمنافع التي يقدمها الصندوق للمستحقين..
ومن هنا فإن موضوع الملاءمة الذي يفرض عملية إصلاح نظام الضمان والتأمينات الاجتماعية على جانب كبير من الأهمية، باعتباره المحرك الدافع لاستمرار النظام في أدائه لوظيفته، من خلال توفير مستويات مقبولة من الحماية والأمان الاجتماعي لأفراد المجتمع سواء العاملين في القطاع المنظّم أو أولئك العاملين في القطاع غير المنظّم(الاقتصاد غير الرسمي).
العاملون في القطاع غير المنظّم:
يشكّل العاملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي) جزءاً مهماً من حجم العمالة في مختلف المجتمعات والدول، وهي نسب تتفاوت من اقتصاد إلى آخر، ويصل حجم العمالة في القطاعات غير المنظّم في دولة مثل مصر مثلاً إلى حوالي 60% من إجمالي القوى العاملة المصرية بما فيها العمالة في القطاع الزراعي، ويتزايد حجم هذه الشريحة في المجتمعات ذات الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة في الغالب، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل تكفي لطالبي العمل والتوظيف.
وتثور مشكلة شمول العاملين في هذا القطاع بمظلة الحماية الاجتماعية، نظراً لغياب التنظيم، وغياب المعلومة الدقيقة بشأن هؤلاء العاملين وقطاعاتهم الاقتصادية، إضافة إلى عدم سعي الدول والحكومات إلى محاولة ضبط هذا القطاع، وسنّ التشريعات اللازمة لتنظيمه، ومع ذلك فإن ما ينتجه العاملون في هذا القطاع من سلع وخدمات في الاقتصاد يبقى ذا أثر وأهمية، على الرغم من التأثيرات والانعكاسات السلبية الأخرى الناتجة عن تضخّم هذه الفئة وتأثيرها على القطاعات الرسمية.
منْ هم العاملون في القطاع غير الرسمي:
معظمهم من العاملين لحسابهم الخاص، دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الدولة.. وتم تعريفهم في المادة الأولى من التوصية العربية رقم (5) بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظّم: مجموعة الأفراد والوحدات التي تمارس أنشطة مشروعة وتنتج سلعاً وخدمات أو تقوم بتوزيعها، وتعمل لحسابها أو لحساب الغير بدون تراخيص من الجهات المعنية المختصّة ولا تشملها الحماية التشريعية أو الاجتماعية.
وتشمل فئة القطاع غير المنظّم: العمال والزُرّاع والتجاّر والصنّاع وكل منْ يمارس نشاطاً اقتصادياً بمعزل عن رقابة الحكومة وتشريعات الدولة الضريبية وسجلاّتها الرسمية، سواء أكانوا عمالاً بأجور، أو عاملين لحسابهم الخاص..
المشكلة في الأردن: تقول الإحصائيات الرسمية بأن نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي (القطاعات غير المنظمة) تصل إلى حوالي 40% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، ومعظم هؤلاء يفتقدون للحماية الاجتماعية، ويعملون في بيئات عمل محفوفة بالمخاطر، إضافة إلى كونهم عُرضة في أي وقت لفقدان القدرة على العمل بسبب البيئة غير اللائقة في عملهم، والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى أبسط معايير السلامة.
حماية العاملين في القطاع غير الرسمي:
يتعرض العاملون في هذا القطاع إلى ظروف عمل صعبة، ويفتقدون الحماية اللازمة التي يتمتع بها العاملون في القطاعات المنظّمة، ومن أهم الآثار السلبية على العاملين في القطاع غير المنظّم، وعلى الاقتصاد:
1. حرمانهم من الأمان والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فلا عقود عمل وبالتالي لا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي لهم ولأفراد أسرهم.
2.التعرض لظروف عمل قاسية نتيجة عدم توفير بيئة العمل اللائقة مما نصّت عليها التشريعات.
3.غياب الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية مما يعرّض حياتهم للخطر.
4.حرمانهم من التدريب والتعليم التقني المستمر والتطوّر.
5.عدم الخضوع للنظام الضريبي للدولة وما يتركه ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد ومالية الدولة.
6. حرمان صناديق التأمينات الاجتماعية من موارد مالية نتيجة عدم شمول هذه الشريحة العريضة بمظلتها.
7.تشجيع توظيف العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية..
8.التأثير السلبي على منتجات وخدمات القطاع المنظّم، نظراً لتنافسية أسعار منتجات القطاع غير المنظّم..
9.ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمستهلك وبخاصة المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها في غياب من الرقابة الصحية..!!
10.ضعف الجودة.
التوصية العربية لحماية العاملين في القطاع غير المنظم:
أصدر مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والأربعين(سبتمبر 2014) التوصية العربية رقم (9) بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنتظم.
ونصّت التوصية على حق العاملين في الآتي:
-المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية من تعليم أساسي، ورعاية صحية أساسية، وإعانات ومعاشات في حالات العجز والوفاة والشيخوخة.
-التدريب التقني والمهني لرفع مستوى إنتاجيتهم.
-التنظيم النقابي والانضمام للمنظمات المهنية..
-ضمان حق المرأة العاملة والأطفال المنتسبين لهذا القطاع، وخاصة حقهم في التمتع بظروف وبيئة العمل اللائقة.
كما دعت التوصية الدول إلى السعي إلى الإدماج التدريجي للعاملين في القطاع غير المنظّم في القطاع المنظّم من خلال إيجاد التشريعات والأليات والبدء بالمشروعات والأشخاص الذين يمكن تسجيلهم وتنظيم عملهم وشمولهم بالتشريعات العمالية ونظم التأمينات والضمان الاجتماعي.
كما دعت التوصية الدول إلى اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة بتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الانتاجية أو الخدمية الصغيرة والمتناهية بغرض إدماجها في القطاع الاقتصادي المنظّم بشكل تدريجي ومن هذه الاجراءات:
-وضع استراتيجيات وطنية لتوفير الحماية للعاملين في هذا القطاع بمجرد تسجيلهم رسمياً.
-تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيعهم على ممارسة نشاطاتهم بشكل رسمي.
-المساعدة في تسويق منتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم على إقامة تعاونيات وأسواق ومعارض.
-حماية أجورهم لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور المعتمد في الدولة.
-تحسين شروط وظروف عمل هذه الفئة وتقديم الاستشارات لها تمهيداً لإدماجها في القطاع المنظّم.
أبرز أسباب ضعف الحماية الاجتماعية بشكل عام:
-عدم وجود خارطة طريق واضحة المعالم للحماية الاجتماعية نظراً لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية لمستحقيها.
-ارتفاع معدلات البطالة وضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل كافية للباحثين عن العمل.
- ضعف معدّلات الأجور بشكل عام، وخاصة للعاملين في القطاعات غير المنظمة( المتوسط العام لأجور المشتغلين في المملكة حوالي 530 ديناراً).
-تآكل الطبقة الوسطى بسبب التضخم، وتحرير أسعار بعض السلع، وعدم ربط الأجور بمعدلات التضخم السنوية وخاصة للعاملين في القطاع الخاص (المؤسسات الصغيرة).
-أشكال وصور الفساد المالي والإداري.
-ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية مما يرفع من نسب الإعالة في المملكة وبالتالي يرفع من نسب الفقر، حيث تراوحت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة ما بين 13.2% إلى 14.5% (معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية أي قوة العمل من الإناث إلى السكان من الإناث من سن 15 سنة فما فوق)، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة جداً من الإناث في الأردن غير نشطات اقتصادياً، على الرغم من الاستثمار العالي في تعليمهن تعليماً عالياً ومتوسطاً..!
-توسّع الطابع غير المنظم لقطاع عريض من العمل، وتوسّع التوظيف في هذا القطاع، مما يحرم العاملين فيه من الكثير من حقوقهم الأساسية، ولا سيّما الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، حيث هناك 440 ألف عامل وافد يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي)، إضافة إلى أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في القطاع غير الرسمي والذي يقدّر عددهم بما يزيد على (400) ألف مشتغل أردني.
-اتساع رقعة الفقر في المجتمع.
-عدم تكييف أو مواءمة سياسات التشغيل مع سياسات التعليم والتدريب والتقاعد.
إشكالية شمولهم بالتأمين الاجتماعي (الضمان):
تتعامل نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية مع قطاعات العمل الاقتصادية المنظّمة، في القطاعين العام والخاص، حيث يتم شمول العاملين في هذه القطاعات من خلال المنشآت التي يعملون لديها، باعتبارها مسجّلة ومرخّصة من الجهات المعنية، وبالتالي من السهولة على أجهزة التأمينات الحصول على المعلومات والبيانات الكافية عن هذه المنشآت وطبيعة عملها وأعداد العاملين فيها..
لكن المشكلة تثور حين يتم الحديث عن شمول العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة بمظلة التأمينات الاجتماعية، نظراً لغياب المعلومة، وعدم توفّر البيانات الكافية عن العاملين في هذه القطاعات وظروف عملهم، وأجورهم وغير ذلك، مما يحرم هذه الشريحة العريضة من أهم ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية وهي التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، لا سيّما وأن العاملين في هذه القطاعات هم الأكثر حاجة إلى الحماية وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية بسبب ما يتعرضون له من مخاطر مهنية في أعمالهم، ناتجة عن عدم الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية التدريب والتأهيل اللازمين لممارسة أعمالهم ومِهَنِهم، وربما غياب هذا التدريب تماماً، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر المهنية وحوادث العمل وإصاباته.
مما سبق نرى أن العاملين في القطاع غير المنظّم هم فئة مهمّشة لا تكاد الدول والحكومات تُلقي لها بالاً، على الرغم من أهميتها ودورها في الاقتصاد، مما يضع المزيد من المسؤوليات على كاهل الحكومات لإيلاء هذه الفئة العريضة الاهتمام اللازم والكافي وذلك لفائدة الاقتصاد ولفائدة العاملين في هذا القطاع، ولفائدة المواطن والمستهلك.
من هذا المنطلق فإن شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلة التأمينات الاجتماعية قد يشكّل بداية مهمة لحماية هذه الفئة وتنظيمها وإدماجها في القطاعات الاقتصادية المنظّمة، كما يشكّل شمولها ضرورة وطنية وإنسانية واقتصادية في كل الدول، إذْ لا يجوز الحديث عن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية في ظل بقاء شريحة واسعة من العاملين خارج هذه المظلة، لا سيّما مع علمنا أنها شريحة تتعرض لمخاطر حقيقية في عملها، تستدعي توفير كل سُبُل الحماية اللازمة لها، وهذا هو التحدي الماثل أمام نظم وأجهزة التأمينات والضمان الاجتماعي.. ولكن ما السبيل إلى ذلك..؟!
الانعكاسات الايجابية لتوسيع مظلة الضمان لشمول قطاعات العمل الصغيرة:
تُشكّل قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية الصغر الجزء الأكبر من عدد المنشآت في مختلف المجتمعات، وتعاني معظم هذه المنشآت من غياب التنظيم، وفقدان العاملين فيها (يزيد عددهم في الأردن على ثلث إجمالي عدد المشتغلين) للكثير من حقوقهم العمالية، وتكمن أهمية شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية في الآتي:
-تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة ,وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وبالتالي فإننا سنقلص من أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة المتقدمة وتنتهي خدماتهم دون الحصول على دخل تقاعدي، ودون أن تكون لديهم القدرة على مواصلة العمل، وبالتالي فإن هذا التقليص سيسهم دون شك في الحد من الفقر في المجتمع وبخاصة بين الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة للحماية والأشح عرضة للفقر، وقد أثبتت إحدى دراسات مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية بأن الدخل التقاعدي يسهم في خفض الفقر في المجتمع بنسبة لا تقل عن (7%).
-تأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، فبينما لن يحظى بذلك العاملون غير المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فإن المشتركين بالضمان سيتمتعون بهذا التأمين ومنافعه العديدة، وهو ما سينعكس بدوره على شعورهم بالراحة والأمان في أعمالهم، خصوصاً إذا عرفنا أن مدد الاشتراك المطلوبة في مواجهة هذه المخاطر للحصول على هذه المنافع قصيرة. فالمدة للحصول على راتب الوفاة الطبيعية إذا حصلت الوفاة أثناء الخدمة هي (24) اشتراكاً، وفي حالة راتب العجز الطبيعي المدة (60) اشتراكاً فقط، وذلك كما في قانون الضمان الأردني.
-حفّز المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاعات العمل الصغيرة، ومن المعروف أن هذه القطاعات هي الأكثر توليداً لفرص العمل، كما أن قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة سواء أكانت شبه منظمة أو غير منظمة تساهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي (الأردن مثالاً) وهي مساهمة مهمة لا يستهان بها، وشمول العاملين في هذا القطاع بالضمان، سيشجع الباحثين عن عمل على الالتحاق بالفرص المتاحة ضمن هذا القطاع، وعلى مواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات هذا السوق، وهذا سيدفع باتجاه تخفيض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
-تعزيز الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم، والتقلب الدائم في العمالة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين وبالتالي يدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، بدل ما كان يعاني منه السوق من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة، وقد كشف الإحصائيات لسنوات عديدة تقلّب آلاف العمال في الأردن بين أكثر من جهة عمل خلال فترات لا تتعدى الستة أشهر في كل عام. ولا يخفى ما لذلك من كلف مالية عالية وخسائر تلحق بأصحاب العمل نتيجة فقدانهم خبرات قاموا بتدريبها وتأهيلها، مما سيضطرهم إلى توظيف عمال آخرين والإنفاق على تدريبهم وتأهيلهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الإنتاج.
-حماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، وبخاصة الذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مما يؤهل البعض منهم للعودة والاندماج بسوق العمل من جديد.
التأمين والضمان الاختياري:
من الحلول التي فكّرت بها ونفّذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن في هذا الشأن، هو إتاحة فرصة الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي (بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) للمواطنين الأردنيين العاملين في القطاع غير المنظّم، وهو اشتراك فردي قائم على رغبة الفرد، ويوفر مظلة حماية جيدة لهم، لكنه لا يشملهم بكافة التأمينات المنصوص عليها والمطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، وإنما يشملهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لكنه لا يشملهم بتأمين إصابات العمل، على أهمية هذا التأمين الذي يتضمّن الأمراض المهنية..!
لكنها، في كل الأحوال، خطوة في اتجاه تحقيق ولو حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظّم، وتقوم المؤسسة بتنفيذ حملات إعلامية توعوية موجّهة للعاملين في القطاعات غير الرسمية لتشجيعهم على المبادرة للاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي والاستفادة من المنافع وسُبُل الحماية التي يوفرها لهم هذا الاشتراك.
كما أن المؤسسة من خلال قانون الضمان الاجتماعي قامت بإعادة تعريف مفهوم «المؤمن عليه» بحيث أصبح هو الشخص الطبيعي وليس العامل بأجر فقط، مما ينسحب على فئات جديدة في المجتمع ويتيح لها فرصة الاشتراك بالضمان كأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وربات المنازل، والمغتربون الأردنيون العاملون خارج المملكة(القانون الجديد للضمان رقم 1 لسنة 2014).
أفكار ومقترحات لتسهيل شمول هذه الفئة بمظلة التأمينات:
أعتقد أن على الدول ممثلة بمؤسسات وهيئات التأمينات والضمان الاجتماعي أن تفكّر جدياً بطرق وآليات تُسهّل إنضواء العاملين في القطاع غير المنظّم تحت مظلتها، وفي هذا الصدد، فإنني أضع عدداً من الأفكار والمقترحات على النحو التالي:
1) السعي لإدماج العاملين في هذا القطاع تدريجياً بالقطاع المنظّم، ووضع الخطط اللازمة لذلك.
2) وضع محفّزات للعاملين في هذا القطاع لتشجيعهم على تسجيل أعمالهم ومشروعاتهم ومهنهم.
3) دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية، عبر الإقراض والتدريب والتأهيل لامتصاص العاملين فيها ضمن القطاع المنظّم.
4) تسهيل إجراءات التعامل مع العاملين في هذا القطاع في حال تسجيل أعمالهم ومشروعاتهم سواء من ناحية الالتزام الضريبي ومنحهم تخفيضات ضريبية مناسبة، أو من ناحية رسوم التسجيل والترخيص بحيث تكون مشجّعة لا منفّرة.
5) سن نظام تأمين صحي مشجّع ومدعوم حكومياً للعاملين في القطاع غير المنظّم قائم على الرغبة والاختيار، مما يسهّل تدريجياً عملية تسجيل هذا القطاع.
6) تشجيع تأسيس التعاونيات والجمعيات التي تضم فئات مهنية من العاملين في هذا القطاع، على نمط جمعية بائعي أطعمة الشارع في محافظة المنيا بمصر التي لعبت دوراً مهماً في تنظيم العاملين في هذا القطاع وأن تؤسّس للتعاون بين الحكومة وبائعي الأطعمة الجائلين، وأن تحمي حقوقهم، وتضمن سلامة ما يبيعونه من أطعمة، من خلال مصاحبة مسؤولي الصحة للباعة وتنظيم دورات تدريبية لهم في كيفية تداول الأطعمة والنظافة الشخصية، وتصميم عربات خاصة لهم، وساهمت الجمعية في تطويؤ عمل العاملين في هذا القطاع وإيصال الرعاية الطبية لهم ولأسرهم.
7) تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية للعاملين في القطاع غير المنظّم تستهدف تشجيعهم على تسجيل وترخيص مشروعاتهم وأعمالهم، للاستفادة من التشريعات الوطنية والحماية التي توفرها لهم ولأفراد أسرهم.
8) وضع إطار مرن للتفتيش على القطاع غير المنظّم، لا ينظر إليه نظرة مناوئة وإنما نظرة إيجابية تتوخّى مصلحة العاملين فيه وخدمتهم وحمايتهم.
9) تسهيل إجراءات انضمام العاملين في القطاع غير المنظم للنقابات العمالية عبر اعتراف هذه النقابات بأنشطة القطاع غير المنظّم، وتخفيف شروط قبول هؤلاء العاملين في النقابات.
10) إضافة إلى ما سبق، فإن على مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي أن تُعيد تصميم برامجها وأن تضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً مناسباً خاصّاً بالعاملين في القطاع غير المنظّم، كأنْ يتم التعامل مع مشروعات ومهن العاملين في هذا القطاع كمشروعات ومهن مرخّصة بمجرّد تسجيلها لديها، بهدف شمول هؤلاء العاملين بمظلة تأميناتها الاجتماعية.